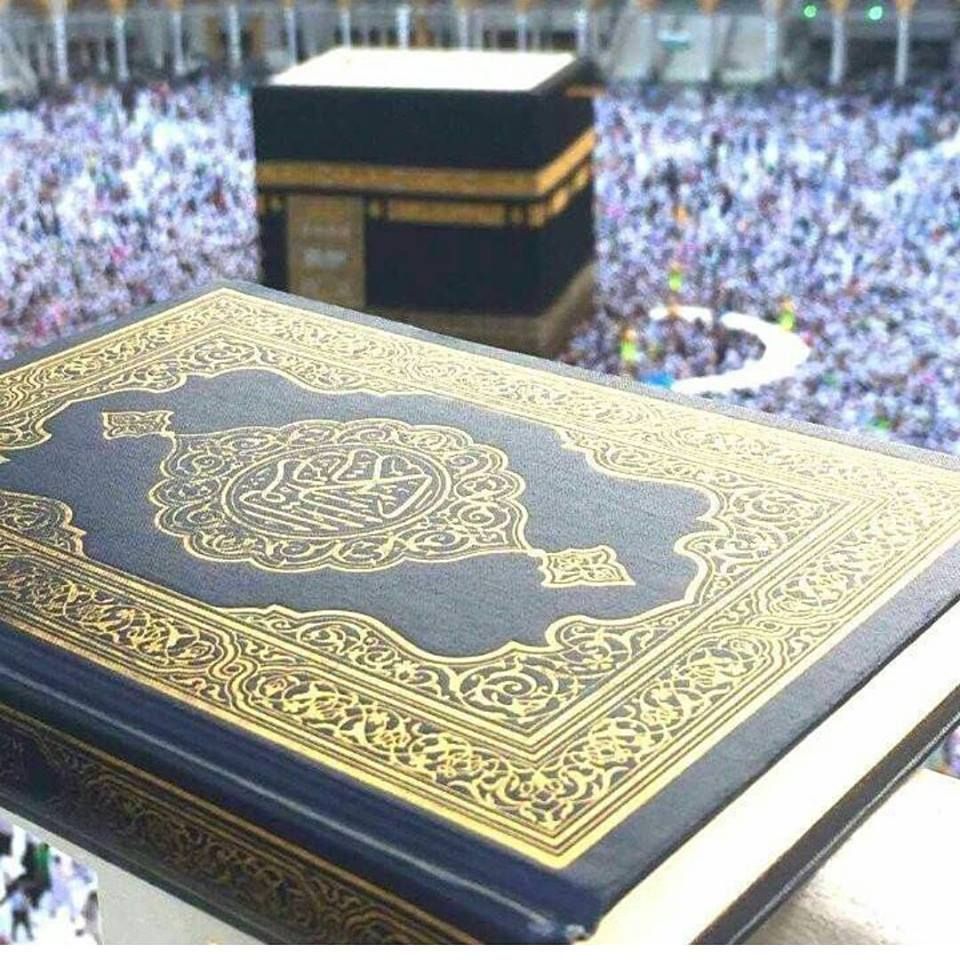﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾
ليست هذه الآية توجيهًا عابرًا في سياق تربوي، بل منهجٌ كامل في بناء النفس، وضبط البوصلة القلبية وسط ضجيج القيم المتبدّلة.
فالله تعالى لا يأمر نبيَّه ﷺ فقط أن يُجالس الصالحين، بل أن يصبر نفسه معهم؛ لأن هذا الطريق، وإن كان أصفى أثرًا، إلا أنه أشق على النفوس التي تألف المظاهر وتُفتن بالوجاهات.
جاء الأمر الإلهي في سياقٍ دقيق؛
حين طلب بعض سادة قريش إبعاد فقراء الصحابة عن مجلس النبي ﷺ، بحجّة أن هيئتهم لا تليق بمجالس “الأشراف”. فجاء الرد القرآني حاسمًا:
الميزان ليس بالمال ولا بالجاه، بل بالقلوب التي تدعو ربها بالغداة والعشي، وتطلب وجهه خالصًا، لا حظًّا من حظوظ الدنيا.
﴿واصبر نفسك﴾ أي احبسها، واثبت بها، ولا تنساق وراء إغراءات الزينة الاجتماعية.
فالصحبة الصالحة لا تُغريك دائمًا، لكنها تُزكّيك. قد لا تمنحك بريقًا، لكنها تمنحك بصيرة. قد لا ترفع اسمك بين الناس، لكنها ترفع قدرك عند الله. ولهذا قال تعالى بعدها: ﴿ولا تعدُ عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا﴾، لأن الانبهار بالظاهر بداية الانفصال عن الجوهر.
واللافت أن الآية لم تصف الصالحين بكثرة صلاة أو علمٍ فحسب، بل بوصفٍ قلبيٍّ جامع: ﴿يريدون وجهه﴾.
فالصحبة التي تُصلحك هي التي تذكّرك بالآخرة دون وعظٍ مباشر، وتدفعك إلى الطاعة دون ضغط، وتعيد ترتيب أولوياتك من غير خطب طويلة.
قال الإمام الشافعى:
أُحِبُّ الصالِحينَ وَلَستُ مِنهُم
لَعَلّي أَن أَنالَ بِهِم شَفاعَه
وَأَكرَهُ مَن تِجارَتُهُ المَعاصي
وَلَو كُنّا سَواءً في البِضاعَه
وختامًا:
إن الإنسان ابن بيئته، مرآة مجالسه، وصدى من يُخالط. فمن جالس أهل الذكر، تعلّم السكينة، ومن لازم أهل الدنيا، تعلّم القلق. لذلك لم تكن هذه الآية خطابًا للنبي ﷺ وحده، بل رسالة لكل من يبحث عن صلاح قلبه:
إن أردت أن تُصلِح نفسك… فابدأ بصحبتك.